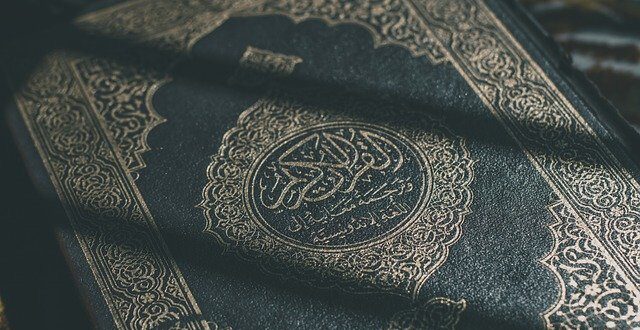(بحثا عن وحدة القياس، من مقام العجز والتسليم)
لو أخذنا كلام الله تعالى، أي القرآن الكريم، الذي بين أيدينا (وهو ما فعلتُه وجرَّبته مرارا، وأنصح بهذه التجربة الفريدة) ثم حاولنا أن نلاحق بعقولنا “المسافات الزمنية المتعاقبة” بين ثنايا الآية، ولا أقصد طبعا “أزمنة الفعل” (الماضي والحاضر والمستقبل)، وإنما أقصد الأزمنة التي دلَّ عليها النص، والتي وصفها، والتي أرادنا أن نتفكَّر فيها؛ لو فعلنا ذلك، فما هي وحدة قياس هذه المسافة الزمنية بين ثنايا النص القرآني؟
يختلف معيار القياس باختلاف الشيء المقيس، فإن يكن ما نقيسُه غرفة أو حائطا مثلا، فإننا نستعمل “المتر”، وإن يكن مسافة بين المدن والدول نستعمل “الكيلومتر”، أمَّا إذا قسنا المسافة بين الكواكب والمجرَّات فإنَّ “السنة الضوئية” هي المعيار المعتمد، وقياس المسافات الصغيرة يستعمل فيه “النانومتر” وهو جزء من مليار جزء من المتر، يستعمل عادة في المستوى الذريِّ.
أمَّا زمنيا فيُعتمد “اليوم، والأسبوع، والشهر، والعام، والقرن” وحداتٍ لقياس الزمن في مستوى حركة الإنسان والطبيعة؛ ثم كانت “الساعة الآلية” وحدةً محورية قسِّمت إلى أجزاء حسب الحاجة والمجال، “فالدقيقة، والثانية، والميلي ثانية، والميكرو ثانية”، إلى أن نصل إلى “الفامبتوثانية” (وهو اكتشاف أحمد زويل) وهو جزء من الثانية مقسَّمة على واحد متبوع بخمسة عشر صفرا، أي هو جزء من مليون مليار جزء من الثانية (النسبة بين الثانية والفمبتو ثانية، كالنسبة بين الثانية و32 مليون سنة).
والآن لو حاولنا أن نأخذ نصًّا من الأدب لكاتِب شهير، ثم اجتهدنا في التنقل بين ثناياه بعقولنا، عبر الزمن الوارد فيه، فإننا على الأرجح لن نجد عنتًا شديدا، إلاَّ أننا قد نسافر نحو الماضي أو حتى المستقبل، بآلاف السنين؛ وهذا لا يكلِّفنا الكثير من التمارين العقلية الرياضية، علما أنَّ الفيزياء والكوسمولوجيا، في مستوياتها العليا، هي تمارين رياضية تخيلية، قبل أن تكون حسابات وتجارب ميدانية، ولذا كانت نظريات، ولم تعتبر حقائق علمية ثابتة.
لكن، لو أخذنا كلام الله تعالى، أي القرآن الكريم، الذي بين أيدينا (وهو ما فعلتُه وجرَّبته مرارا، وأنصح بهذه التجربة الفريدة) ثم حاولنا أن نلاحق بعقولنا “المسافات الزمنية المتعاقبة” بين ثنايا الآية، ولا أقصد طبعا “أزمنة الفعل” (الماضي والحاضر والمستقبل)، وإنما أقصد الأزمنة التي دلَّ عليها النص، والتي وصفها، والتي أرادنا أن نتفكَّر فيها؛ لو فعلنا ذلك، فما هي وحدة قياس هذه المسافة الزمنية بين ثنايا النص القرآني؟
رغم أنَّ السؤال هو افتراض علميٌّ مجرَّد، وهو في حاجة إلى بحوث مكثفة، إلاَّ أنَّ بعض الأمثلة كفيلة بإيضاح الغرض وتقريب الجواب.
خذ مثلا نصا من رواية “الصعود إلى الهواء” لـجورج أورويل، واقرأ قوله:
“…في اليوم التالي، لم تقرَّ العصابة أني عضو فعليٌّ فيها، وإنما يجب أن أتجاوز امتحانها الصعب، وهو عبارة عن أشياء استوحوها من قصص الهنود الحمر، وكانوا صارمين في ذلك…”
إنك لا تحتاج إلى أكثر من وحدة قياس بسيطة هي اليوم “اليوم التالي”، ثم في المستقبل “يجب أن أتجاوز امتحانها” وقد يكون ذلك مقاسا “بالشهر” أو “العام”، وأمَّا في الإحالة إلى الهنود الحمر، وإلى عاداتهم، فإنَّ “القرن” يكفي للإشارة إلى تاريخهم، حتى ولو كان ذلك بعشرات “القرون” مثلا. وينتهي النصُّ عند هذا الحدِّ.
أمَّا لو أخذت آية من كلام الله تعالى، من أيِّ سورة شئتَ، وفي أيِّ موضوع أردتَ، ولو كان ذلك الانتقاء عشوائيًّا؛ فإنَّك ستجدها منفتحة على “الزمن اللامتناهي” بصيغ كثيرة، مما يجعلك “عاجزا عن توظيف وحدات القياس الفيزيائية البسيطة”، ولا بدَّ أن تكون في حاجةٍ إلى “وحدة قياس مصدرها الوحيُ، وبُعدها غير متناهٍ”، فمثلا نقرأ قول الله تعالى:
"إنا أعطيناك الكوثر، فصلِّ لربك وانحر، إنَّ شانئك هو الأبتر"
وهي أصغر سورة من كلام الله تعالى؛ ونسأل: ما هي المسافة الزمنية التي تشغلها هذه السورة؟ ولو أننا سافرنا عبر الآيات وأبعادها الزمنية، ما هي الوحدة التي نوظفها في ذلك؟ وهل يمكن قياس هذه المسافة؟
من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطَب في الآية، فإننا في حاجة إلى “قرون” للعودة إلى عصره، أي عصر السعادة؛ كذلك في الحديث عن شانئه، وهو العاص بن وائل السهمي، كذلك المعتمد هو “القرون” للعودة إلى عصره؛ لكن لو ركَّزنا على الزمن المؤرِّخ لـ “الكوثر” فإنَّ الرسول عليه السلام يبين لنا أنه “نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة…” فالزمن الأرضي هنا لا يواتينا، والحاجة إلى زمن متجاوز لظروف الفناء إلى ظروف البقاء؛ ووحدة القياس الطبيعية، مهما كانت، لا تسمح لنا بقياس المسافة الزمنية بيننا وبين هذه “الحالة”: حالة الكوثر.
ولو تتبعنا “صلاة الرسول” عليه السلام الواردة في السورة “فصلِّ”، ثم نحرَه “وانحر”، ولو بحثنا عن زمن ذلك كلِّه؛ فإنَّ الفعل في الظاهر يبدو دنيويا (الصلاة والنحر)، يُنجَز في “ساعات أو أيام”، أو أكثر من ذلك أو أقلَّ بقليل؛ لكن لو ركزنا على محتوى الصلاة، وعلى ما يرد فيها، وعلى أثرها على “العقبى والآخرة والخلود”؛ فإنَّ وحدة القياس كذلك تكون متجاوزة لسياقات الأرض والآن، إلى سياقات لا نهائية.
أمَّا ضمير الجلالة “إنا” المشير إليه سبحانه وتعالى، واسمه الكريم “ربِّك”، فهو “فوق الزمان”، و”فوق المكان”، وفوق كلِّ قيد وحدٍّ وقياسٍ؛ ومع ذلك فقد وردت الإشارة إليه في الآية الكريمة بالحروف والكلمات والمعاني؛ والعقل يجتهد في تعقُّله، وفي تصوُّر مداه وبُعده؛ ثم ينتهي إلى أنه لا يدركه حقَّ الإدراك، ذلك أنه سبحانه وتعالى “لا تدركه الأبصار” ولا الآذان ولا العقول ولا المسافات والقياسات؛ ولا غيرها من وسائل الإدراك، وهو يدركها.
ووحدة القياس الوحيدة هنا هي “مقام العجز”، ذلك أنَّ “العجز عن إدراكه إدراك”، أما “الخوض” فهو نوع من الزلل والخطل، أي هو “إشراك”؛ ثم إنَّ وحدة القياس لطفٌ من الله تعالى يلقيه على قلب المؤمن، ويغمر به عقله، فيرتقي إلى مقام “التسليم”، ويكون التسليم المطلق لله هو الحدُّ الأعلى لإدراك المسافات الزمنية التي تحيط بالآية.
ولكن، لو تأمَّلنا حروف الآية، وكلماتها، ودلالاتها… وأنها كانت هنالك، في اللوح المحفوظ، مصدرها ربُّ العزة سبحانه، هو الذي أنزلها على قلب رسوله الحبيب عليه السلام؛ لو تأملنا هذا المعنى، وتتبعنا المسافة الزمنية التي تشغله، فإننا نعلنها صراحة: “سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علَّمتنا”… ونحيل إليه وحده، من مقامين أساسيين، هما: “مقام العجز”، و”مقام التسليم”.
ولو أنَّ تفسيرا للقرآن الكريم لم يعنَ بما يدركه العقل، وبما تحويه الدلالة، وبما يُفهم لغةً ومعنى؛ وإنما تتبع “ما لا يدركه العقل”، وما “لا تحويه الدلالة”، وما “يندُّ عن الزمان والمكان”؛ ثم أحال إليه؛ أي إلى “رقعة المجهول” عندنا، الواسعةِ جدا، بل اللامتناهية: “وما أوتيتم من العلم إلا قليلا”، “ما نفدت كلمات الله”؛ لو أنه فعل، لنبه العقل البشريَّ المعتدِّ بنفسه إلى “حدِّه وحدوده”، ولكشَف عن “السقف” الذي ينبغي أن يتوقف عنده هذا العقل، لِيشير إليه سبحانه، ويعلن أمامه “عجزه وتسليمه”: “سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علَّمتنا”.
لو أنَّ تفسيرا قام على هذا الأساس، لفتَح آفاقا واسعة، لما يمكن إدراكُه، وفروضا كثيرة لما يمكن اكتشافُه، أي أنه سيحرِّر العقل من “شِبه التسليم” الذي ليس مِن روح الدين، إلى التسليم الذي يستدعي التفكير والبحث والاجتهاد؛ ومِن شِبه العجز، الذي نهى عنه الشارع سبحانه، إلى حالة العجز التي هي توكل على الله، واتخاذ للأسباب في حدود ما أمر به، وطلب للأسمى والأعلى باسم الله وحده: “يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا، لا تنفذون إلاَّ بسلطان”.
فهلاَّ تحرَّرنا من ضيق عقولنا المجردة إلى سعة عقولنا المؤيدة، وإلى مقامات الرضا والتوكل، باسم الله، وبعون من الله، وبمعية الله، وبابتغاء ما عند الله؟
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت