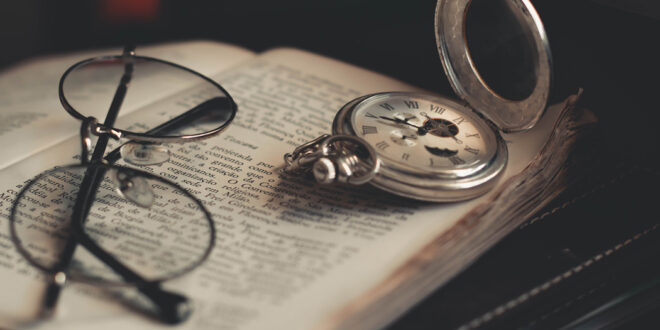كلَّما تقدمت في البحث أكثر؛
وكلَّما استفرغت من الزمن قسطا أكبر؛
وكلَّما منحت الفرصة للقراءة المتأنية والتفكير المتواصل، فلم أفتُر؛
كلَّما فعلتُ ذلك اتضحت لديَّ صورة “علم الزمن والوقت”، مثل جزيرة يراها الناظر من بعيد نقطة سوداء، ثم يقترب منها نزولا من الطائرة، فتكبر وتكبر، وتظهر تضاريسها، وتتشكَّل معالمها… إلى أن يضع رجله الأولى على تربتها؛ ثم يسير على ظهرها، ويمشي على مناكبها، ويذوق ماءها، ويطعم من ثمرها، ويتعرَّف على أهلها… ولا يزال يكتشف أعماق أفكارهم، وأسرار قلوبهم، وماضيهم وحاضرهم، وآمالهم وآلامهم…
وهو في هذا لا يدعي أنه أحاط بالجزيرة علما، ولكنه ازداد بها علما، ثم في ذات الأوان يكتشف أنه يزداد بها جهلا؛ وتظهر له خفايا وخبايا، قد يدركها يوما، وقد لا يدركها أبدا…
“علم الزمن والوقت” هو تلك الجزيرة النقطة، ثم الجزيرة في كلياتها، ثم الجزيرة معلومة عين اليقين، ثم الجزيرة في غموضها وأسرارها… هي هكذا، بهذه الصورة الإدراكية أتمثلها.
في عملي العلمي اليومَ أسعى إلى وضع أسس هذا العلم، وأدعي أنَّ الفكر البشري أسَّس علوما للزمن والوقت عبر نموه المعرفي؛ وهو لا يزال يرسم معالم علوم جديدة، موضوعها الأساس هو “الزمن والوقت”؛ ولن يتوقَّف من هذا الجهد الحثيث ما دام الزمن “لغزا وسرا” من أعظم ألغاز الحياة، ومن أكبر أسرار الفكر.
ولقد يكون البناء المعرفي لعلم الزمن والوقت كالآتي، ولما أستقرَّ بعدُ على ظهر الجزيرة، أي أنَّ الاستكشاف لا يزال في أوجه، ومع ذلك لا بدَّ أن أدون ما أنتهي إليه في كل مرحلة من مراحل الولوج على ربوع الجزيرة:
أولا– مدخل معرفي في “ميلاد العلوم”: الأسباب، والمناهج، والأمثلة، والعوائق…
ثانيا– “علم الزمن والوقت”: هل هو علم ممكنٌ؟ ولماذا عزف العقل البشري عن إنشائه؟ وما أثر الصبغة الوضعية في العلوم على قصور إبداعه؟ ولماذا لدينا المسوغات والأسباب التي بها نؤسس لهذا العلم؟
ثالثا– آفة العلم في شكله الحديث: التقطيع، والتفتيت، وحبس الموضوع، أي أنَّ آفة العلم هي “الذرية والاختزال”. وبيان أنَّ العلم في القديم، قبل “عهد التخصص والدقة” لم يكن يعاني من هذه المعضلة، وأنَّ الأعمال المتجاوزة للتخصصات (أو العابرة بين التخصصات) هي شكل من أشكال الصرخة والمعالجة.
رابعا– أنَّ العلم هو المنهج؛ وأنَّ بناء المنهج الذي به يدرس علم ما هو المنطلق لبناء ذلك العلم؛ ويأتي الموضوع “تابعا”، بل يتحوَّل الموضوع إلى منهج؛ والصورة شبيهة بالجوهر والعرض، وسؤال الأسبقية: أيهما يسبق الآخر.
خامسا– معضلة المحورية الغربية لتاريخ العلوم: وأنها اختزلت العلم في “العلم الغربي”؛ وصار شرقنا، وجميع الشرق الآخر، يردد ما يرد إليه من إسناد للعلوم إلى “اليونان” في القديم؛ ثم الانتقال منهم رأسا إلى “النهضة الأوروبية”؛ وكلَّ ما سواها إنما هو “هامش”، و”تبع”؛ بل إنَّ الإنسان خارج دائرة الغرب يتحوَّل بالضرورة إلى “حيوان ناطق”، وإلى “موضوع قابل للدراسة”، وإلى “مستهلك نهم”، وإلى “عبد ينتظر الإذن من مولاه في كل شيء، حتى في بناء العلوم”.
سادسا– التكرار يرسخ الفكرة، وقل للإنسان المبتلى بالولع: “أنت حمار” عدة مرات، فإنه سيكذبك ابتداء، ثم يتردد تباعا، ثم يصدق أخيرا؛ ثم ينتهي إلى أن يقولها لنفسه موقنا بصدقها؛ وهكذا العلم الرسمي اليومَ؛ هو علم ما دام ملونا بلون أبيض، فإذا ما تغير نحو السواد، أو الصفرة، أو أيَّ لون آخر؛ يكون مجرَّد أفكار، لا ترقى إلى مستوى العلم الجدير.
سابعا– يخضع العلم إلى فكرة التشهير، مثل التشهير للأراضي التي لا عقود لها؛ ذلك أنَّ مجرَّد التشهير، مع غياب من يتابع ويلغي التشهير، يعطي المشهر الأحقية والصلاحية في تبنيه وامتلاكه؛ وهكذا اليومَ تسير الأمور في العلوم بعامة، وفي العلوم الزمنية بخاصة.
ثامنا– ليس هذا الوضع قدرا أبديا، وإنما هو ملازم لحالة من التبعية أو التسلط، إذا زالت تغير الأمر؛ ولعلَّ الصين اليومَ مثال حيٌّ على إرادة تجاوز الهيمنة الغربية في عدة مجالات؛ ولا ريب أنها بدأت بالاستيعاب، ثم دخلت مرحلة التجاوز والإبداع؛ والفرصة سانحة اليومَ للاستيعاب ثم التجاوز في مجال العلوم.
تاسعا– أدرك أنَّ “الجهات الرسمية” لن تولي أهمية لإنشاء علم الزمن والوقت، ذلك أنه لا يندرج ضمن “العلم الغربي”، ولا يدور في فلكه؛ وأنه مخالف لنماذجه المعرفية، ولمنطلقاته الأيديولوجية؛ وكذلك سيجد معارضة شرسة من الداخل الشرقي؛ بخاصَّة ممن هو تلميذ مجتهد في مقاعد الدراسة الغربية، وليس لديه أيُّ جهد للتعلم ثم النقد، ثم السؤال والشك، ثم الرفض والتمرد…
عاشرا– يساند كلَّ هذه المقدمات والخطوات، جهد عملي تطبيقي تربوي حضاري، متمثل في “متحف علم الزمن”، الذي يكون سندا ومحكا؛ ذلك أنَّ الرسالة من التأسيس لهذا العلم لا تقتصر على النظر فقط، بل تتعداه إلى الرشد في روحه وروْحه: حركية الفكر والفعل.
بناء على هذه المقدمات أرسم معالم “علم الزمن والوقت”: المنهج، الموضوع، المصادر، التصنيف، المراحل، التقاطع، العلاقات، القرانات، الإشكالات…
ثم أرسم خريطة “علوم الزمن والوقت” (لائحة) المتفرعة عن “علم الزمن والوقت”.
ثم أعالج كلَّ علم (أو فن أو فصل) على حده، من مثل: الغيب والشهادة، الطبيعة وما وراء الطبيعة، الحركة، التقويم، اليوم والليلة، القبلة، الزيج، الأنواء، آلات الزمن، الساعات، الأوفاق، الأكر… إلى الزمن النسبي، الزمن الكمومي، الأوتار الفائقة، الساعة البيولوجية، النوم والأرق، العلاج الزمني، المستقبل والتنبؤ، المبدأ والمعاد، المواليد، الزمان والمكان، التنجيم، الأعياد والمناسبات، الرصد والمراصد، الظل والشعاعات، أعمار المخلوقات، عمر الإنسان، البرمجة الزمنية، الزمن الكلامي، التحرر من الزمن، الله تعالى والزمن، الزمن القرآني …
بطاقة تعريف لكل علم:
- تعريف العلم (وهل موضوع ما هو علم أو فن أو فصل؟)
- تاريخه
- أبرز المؤلفات والمؤلفين فيه
- تحليل الموضوعات التي تناولتها تلك المصادر
- المؤتلف والمختلف بين المصادر
- الوضعية الحالية لذلك العلم
- النقد والبناء (فتح الورشة)
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت