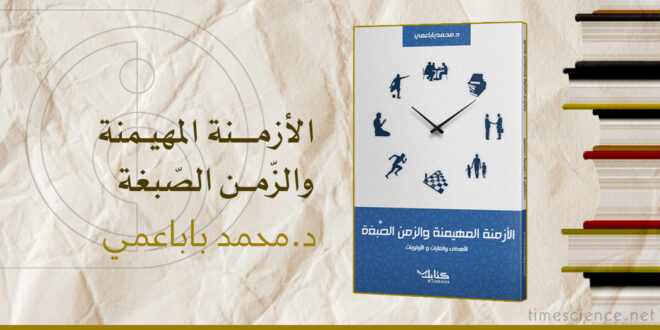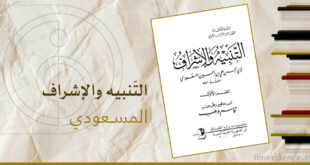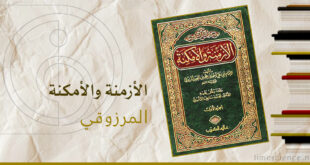»إنك لا تسبح في النهر مرتين» مقولة فلسفية تنسب إلى «هرقلیطس» وهو يريد من هذه الصورة الذهنية أن يعبر عن مبدأ من مبادئ اللوغوس، يقضي بكون كل شيء في سيلان دائم، وليس ثمة ثبات ولا استقرار مطلق، لكن الحاجة اليوم إلى مبدأ جديد، يرسم العلاقة بين «سيلان النهر» و «إرادة الإنسان» فهل النهر هو الذي يتحكم في وجهة السابح فيقهره؟ أم أنَّ للسابح إرادةً يوجه بها حركته ويفرض بها سكونه؟
ولقد ألف روجير سيو كتابا بعنوان «الزمن والنظام الاجتماعي»، وصاغ مفهوم «الأزمنة المهيمنة» (Les temps dominants) باعتبارها تعبيرا عن مسار التاريخ، فهي التي توجه حركة المجتمعات والأفراد؛ ويعرف سيو الزمن المهيمن بأنه «هو الزمن الأساسي والقاعدي، عليه مدار الأزمنة الأخرى، فهو بمثابة قطب موجِّه ومنظِّم للبرنامج الزمني في جميع أشكاله»، ومن ثم فإن النهر قاهر، والواقع متحكم، وما الإنسان سوى قشة تعلو سطح الماء، وتسير حيث التيار يسير.
وتأتي أهداف الإنسان خاضعةً لأهداف المحيط، وغاياته كذلك، ثم تفرض عليه أولويات تفقده حريته، وتؤسس حياته على مبدأ آلي ميكانيكي، ليس له فيه خيار، وتحت وطأة الأزمنة المهيمنة يفقد الإنسان خصوصيته، ويتلون بلون عصره؛ فحين كان «الزمن الديني» هو المهيمن، كان الإنسان دينيَّ الزَّمنِ والحركة والأهداف والغايات والأولويات؛ وحين تحَوَّل الزمن إلى زمن صناعي، دخل بكلياته دواليب المعمل والمصنع، وانغمس في دوران الآلات؛ ثم حين تأسس عصر حضارة الفراغ -بتعبير دومزدييه – صار الإنسان يحوم حول وسائل المتعة والراحة والفراغ، بلا ضابط ولا قيد.
ويأتي هذا المؤلَّف، الذي أدافع فيه عن ميلاد علم جديد، هو «علم البرمجة الزمنية»، مكمّلا لمؤلف سابق ، صادر عن نفس الدار، وهما في الأصل أطروحة علمية وضعتها منذ سنين، ولا أزال أبني عليها خصائص منطلقاتي الحضارية، سواء في المجال النظري/ البحثي، أم في المجال العملي/اليومي.
وقسمت المؤلف إلى ثلاثة فصول، هي: الأزمنة المهيمنة والزمن الصبغة، والأهداف والغايات، ثم الأولويات؛ أقدم لكل فصل بما يلي:
- الأزمنة المهيمنة والزمن الصبغة:
يبدو للوهلة الأولى أن الجمع بين الدين -أي دين كان- وبين التنظيم، الذي يتناسب مع التطور والآلية، ضرب من التناقض. فالبرمجة الزمنية باعتبارها صورة من صور التنظيم، وليدة فكر غربي مصنوع بعهد النهضة، يتسم باستبعاد الدين الذي كان معرقلا لحركته، ذلك «أن الدين في النظر الغربي لا يؤدي إلى التقدم»، فهو «شيء، والضبط الاجتماعي شيء آخر» وأول مظهر من مظاهر المفارقة ـ في بحثنا هذا ـ تتمثل في الملاحظات الآتية:
- غياب الدين من الدراسات الزمنية، كعامل محدد وأساس.
- غياب البرمجة الزمنية كمنحى عام للفكر، أو كعلم قائم بذاته من المؤلفات الدينية، والإسلامية على الخصوص.
- ظهور قيم جديدة في المجتمع الغربي: العمل، الفراغ، مجتمع الإعلام.
- غلبة التفكير الديني على المجتمعات المسلمة من جهة، وهيمنة الأسلوب الغربي في الممارسة اليومية، من جهة أخرى.
هذه المقدمات تدفعنا إلى البحث عن مكانة الدين في البرمجة الزمنية، وتفرض علينا أن ندرس ما يسمى بالأزمنة المهيمنة (Les temps dominants)، سواء في علم اجتماع الفراغ، أو في ” إدارة الوقت”، أو في “ميزانية الوقت ” أو في غيرها.. ثم تعرض بعض المحاولات لإحلال الدين مكانه من خلال الدراسات الإسلامية، مع ما يلاحظ لها أو عليها، وأخيرا، نقدم مقترحا لمفاهيم نراها بديلة.
- الأهداف والغايات في علم البرمجة الزمنية:
من الحكم المتكررة والصادقة قولهم: «إن لم تدر إلى أين تذهب، فلن يهم أي الطرق تسلك»، وينسب للفيلسوف الروماني سينيكا Senecca» قوله: «عندما لا يعلم المرء لأي ميناء هو متجه، فلن يستطيع أن يميز أي ريح هي الريح الصحيحة؛ ولكن للأسف إن هنالك كثيرين يقبلون أي ريح ما دامت تهب».
تجمع الكتب التي ألفت في «إدارة الوقت» أن تحديد الأهداف والغايات هو أول خطوة، فهو من أهم مراحل البرمجة الزمنية، غير أننا بتتبعنا للمراجع الغربية والعربية على السواء، وجدنا أن ثمة إشكالا علميا يتمثل في الخلط بين الأهداف والغايات، وإنزال أحدهما مكان الآخر في كثير من الأحيان، ورغم أن الأمر قد يبدو بسيطا وبدهيا لأول وهلة؛ إلا أن المنهج العلمي يجرني لتعريف الأهداف والغايات رفعا للبس والخلط.
- فما هي الأهداف لغة واصطلاحا؟
- وما هي الغايات لغة اصطلاحا؟
- وما هي الأهداف والغايات في البرمجة الزمنية من خلال الفكر الغربي أولا؟ ومن خلال الفكر الإسلامي ثانيا؟
- وما هي الفروق بينهما؟
- وما هي الإيجابيات والسلبيات في كل منهما؟
هذه أسئلة تبني إشكال الفصل الثاني من هذا الكتاب، وأول خطوة فيه هو التعريف، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتم التصور إلا بإتقان الحد والتعريف.
- الأولويات في علم البرمجة الزمنية
في البدء لم يكن إنسان فوق الأرض، ولم تكن أهداف ولا غايات، كان هناك نظام يضبط إيقاع الحياة. ثم أُنزل آدم عليه السلام من جنة الخلد إلى سطح الأرض، التي أرادها الله له «مستقرا ومتاعا إلى حين».
وهكذا امتلكت آدم الحيرة، وغبط الحيوانات كلها، لما أوتيت من مأكل ومأوى، ولما أمنت من خوف، وازداد في قلبه الندم، حتى ملك عليه نفسه، هنالك رفع يديه إلى السماء (الله) يتضرع، فاستجابت له السماء قائلة: اذهب أيها الرجل، فإني أعطيتك عقلا ويدا، وأعطيتك ترابا وزمانا، فاطمأن أدم عليه السلام وبنوه ردحا من الوقت، حتى بدأت الحياة تتعقد، والرغبات تكثر، ومصالح العباد تتشابك، وأعمارهم تقصر، وآمالهم تكبر…
وهكذا، إلى أن بلغ التعقيد مبلغه، فاحتاج الإنسان إلى مساعدة، ولكنه استنكف عنها، إذ لم يتوجه هذه المرة إلى السماء، بل إلى عقله وباطنه، فاهتدى إلى شيء يعتقد أنه الحل الأمثل لمعضلته، بعد طول بحث وتجريب، إنه ضبط «الأولويات»، وترتيبها، والكف عن الاستجابة للرغبات والطوارئ والضغوطات.
إن الإنسان الغربي قد وضع غاياته، وحدد أهدافه من الحياة، فاحتاج إلى مقياس أو مقاييس يرتب بها تلك الأهداف وفق الغايات، ذلك أن الأهداف أصبحت كبيرة وكثيرة، وهو لا يقدر على الاستجابة لها كلها. من هنا، وفي هذه الظروف بالذات اكتشفت الأولويات كفَنٍّ وممارسة، مع بروز علم إدارة الوقت خلال القرن الماضي.
أما الإنسان الشرقي، فكان بسبب ضعف مداركه ومستواه العلمي في مرحلة تبعيته واحتلاله، ولكونه ساكنا وخاملًا، يسكن خارج دائرة التاريخ، يرضى بالقليل، ويطمئن إلى أهداف روتينية غريزية ضعيفة.. لم يجد الحاجة ملحة للبحث في الأولويات، بحثا عمليا مبتكرا.
كل هذا والفكر الإسلامي قد بلور عبر تاريخه المتقدم علما -بل علوما- تعنى بالأهداف والأولويات، بناء على الوحي وعلى بيان الوحي، لكنها بقيت رهن كتب الفقه، يجهلها المسلم المعاصر، بله المشرك والكافر.
- ما هي الأولويات؟
- كيف يتعامل الفكر الغربي مع الأولويات؟ وما هي نقاط قوته وضعفه؟
- وكيف تعامل الفكر الإسلامي مع الأولـويـات؟ وما هي الإيجابيات؟ والسلبيات؟
- وهل في الإمكان أن نقوم بعمل تأصيلي في مجال الأولويات، يستقي من الفكر الإسلامي عمقه، ومن الفكر الغربي المعاصر تخصصه؟ أم أن ذلك ضرب من الخلط والتلفيق؟
للإجابة على هذه الأسئلة ألف الفصل الثالث من الكتاب، ومن هذه النقطة نبدأ المشوار..
= العنوان: الأزمنة المهيمِنة والزمن الصِّبغة الأهداف والغايات والأولويات – دراسة مقارنة بالفكر الغربي.
= المؤلف: د. محمد باباعمي.
= دار النشر: مؤسسة كتابك – الجزائر.
= الطبعة: الأولى – سنة 1438 هـ / 2017م.
= عدد الصفحات: 192.
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت