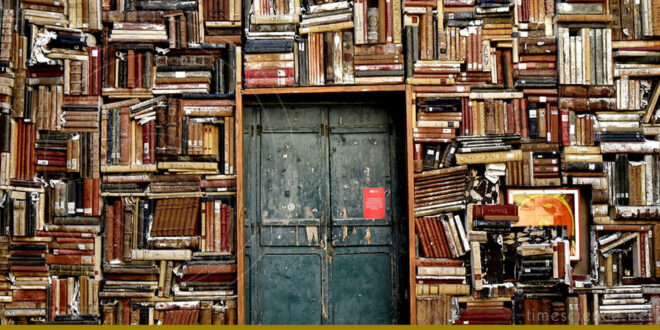أستعير من عبد الوهاب المسيري شطرا من عنوان مذكراته “رحلتي الفكرية: البذور والجذور والثمر”، لأعرض مراحل نشأة علم الزمن والوقت:
- قبل ثلاثين عاما في “المعهد العالي لأصول الدين”: صراع الجمود وأفق الحضارة، رياح التغيير… وكان لأستاذي المشرف الدكتور أحمد موساوي الفضل، وكذا رئيس الجامعة يومها، الدكتور عبد الرزاق قسوم، والأساتذة عبد الرحمن المراكبي، ومحمد الزيني، والدكتور محمد ناصر… وغيرهم.
- في قسم الآداب، كان ثمة صراع الأصالة والميوعة؛ وكان لي الدكتور محمد ناصر جامعة، وأي جامعة، ضمن سياق جمعية التراث.
- التوجه التراثي، وجملة من الأعمال: التحقيق، المعاجم، التأليف، الفهارس…
- التحول نحو مشكلات الحضارة… الزمن أبرز مؤشر على التخلف والحضارة…
- أول بحث: “مراعاة الأحوال النفسية، والظروف الزمانية والمكانية في فهم الآية القرآنية“.
- رسالة الماجستير: “مفهوم الزمن في القرآن الكريم“.
- أطروحة الدكتوراه “أصول البرمجة الزمنية في الفكر الإسلامي، مقارنة بالفكر الغربي“.
- جملة من المؤلفات حول “صورة العلم عند العلماء”: محمد إقبال، ابن باديس، محمد ناصر… وغيرهم. وأنا حاليا مع صورة الزمن عند القطب اطفيش، من خلال مراسلاته (حوالي 4000 صفحة، تحقيق مؤسسة عمي سعيد)
- جاء الاشتغال والانشغال بـ: جمعية التراث، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مكتب الدراسات، المدارس العلمية، معهد المناهج، المعهد العالي للعلوم، بذور الرشد…
- كان بناء “نموذج الرشد” أو ما سمي من قبل “منظومة الرشد” وما أثمر من مؤلفات، ومشاريع، ومواقف، وعلاقات… كان هذا البناء مِفرقيا في التأريخ لـ”علم الزمن والوقت” رغم أنَّه جاء لاحقًا.
- الشكر موصول للعمل الجماعي، وللعقل الجمعي، وللتداول الفكري، وللجيل الجديد الحديد… لله الحمد… تفرغتُ قبل ثلاث سنين بصورة شبه كلية للتأسيس لعلم الزمن والوقت… (لم يكن الأمر يسيرا، من الناحية النفسية، وكان الفضل للجميع في تجاوز الصعوبات)
- تولَّد من هذه الرحلة الفكرية: مفاهيم، ومصطلحات، ومناهج، ونماذج معرفية “منها ما كان تقييدا، ومنها ما كان تمييزا” مثل: الزمن الصبغة، البرمجة الزمنية، علم البرمجة الزمنية، الإعجاز الزمني الإيقاعي…
- ثم ضمن “نموذج الرشد”: نموذج الرشد نفسه، رحلة الفتى، البريق الحرج، الخريطة المعرفية GPS، الوعاء الحضاري، النسيج الحضاري، حركية الفكر والفعل، المتحد العلمي، السياق الحضاري المتأزم، خريطة العلم الجزائري، تفسير بذور الرشد… (إحالة إلى مسرد مفاهيم نموذج الرشد)
الأسئلة التي تتردد هي:
- كيف نفعّل هذه الثمرات؟
- أين نسجّلها؟
- كيف نضمن تشغيلها وتفعيلها؟
- كيف لا تتحول إلى “ملكية خاصة” بل إلى معطى معرفي/فكري/حضاري؟
- إلى أن جاء التفرغ لصياغة “دعوى تأسيس علم الزمن والوقت“، فسخّر لها ثلاث من السنين قراءة، وتحليلا، وتأليفا، وتداولا…
لبلوغ مرحلة “إرساء التقليد” كان من الضروري استدعاء جميع المقدرات والطاقات، والعقول والسواعد، والمواهب والهبات، والأفراد والمؤسَّسات… سواء منها ما كان ماديًّا أو معنويًّا، في الموضوع أو في المنهج أو في الشكل؛ ولقد سبقت لنا تجربة “وسام العالم الجزائري” حيث تحوّل بعد سنوات من مجرَّد حفل إلى “تقليد علميٍّ” نحسب أنه نقلة نوعية في “سياقنا الحضاري“، وهي في حاجة إلى عناية فائقة الحساسية.
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت