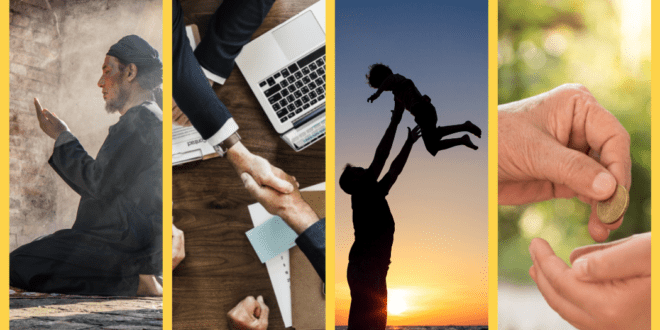المقال مقتبس من كتاب أصول البرمجة الزمنية في الفكر الإسلامي، الفصل السادس.
مدخل:
لكلِّ مؤمن في حياته أُسوتان:
– أُسوة في أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والذين معه من الأنبياء والأولياء.
– وأسوة في خاتم النبيئين محمد ﷺ .
فلقد دعا القرآن الكريم إلى الأسوة الأولى، في قوله:
]قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ (…) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ[ (سورة الممتحنة: الآية 4، 6).
وبزيادة تأكيد، ركَّز كتاب الله تعالى على الأسوة الثانية، فقال:
]لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[ (سورة الأحزاب: الآية 21).
ولكن، فيم تكون الأسوة بخير الخلق، محمَّد عليه السلام؟
في خُلُقه؟ وهو الذي شرِّف بأقدس اعتراف نزل من السماء إلى الأرض: ]وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[ (سورة القلم: الآية 4).
في تشريعه وبيانه لأحكام القرآن؟ وهو من خاطبه الله بقوله: ]وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[ (سورة النحل: الآية 44).
في رحمته بالمؤمنين وسياسته الحكيمة لأمَّته؟ وهو من نزل فيه قرآنٌ يتلى على رؤوس الأشهاد: ]فَبِمَا رَحْمَةٍ مِن اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 159).
في كلِّ ذلك، وفي أكثر من ذلك…
ومن أجل هذا لم يُعرف في التاريخ «رجلٌ منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا، قد نُقلت لنا تفاصيل حياته، ودقائق تصرُّفاته، كما نُقلت تفاصيل حياة رسول الله محمد ﷺ، ودقائق تصرُّفاته.
ولا نعلم سيرة قد نقِّحت، وحقِّقت، ومحِّصت، كما فُعل بسيرة رسول الله »([1]).
ولقد بُحث محمَّد من مداخل كثيرة، لا يحصيها عدٌّ: بُحث كمشرِّع، وكقائد، وكربٍّ لأسرة، وكعابد متفرِّد، وكتاجر نصوح… الخ.
ومع ذلك ستبقى نوافذ من حياة الرسول ﷺ مفتوحةً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولعلَّ في هذا سرًّا من أسرار صلاحية الإسلام لكلِّ زمان ومكان.
ونستسمح التاريخ والمؤرِّخين، والإدارة والإداريِّين، والاجتماع والاجتماعيِّين… في محاولة لفتح كوَّة ولو صغيرة، في نافذة لا شكَّ ستكبر مع مرور الأيام، عنوانها:
علاقة الرسول ﷺ مع الوقت كإنسان، لا من جانب واحد، ولكن من جوانب متفرِّقة:
– كيف كان محمَّد ﷺ يخطِّط يومه ويبرمجه؟
– وما هي أبرز خصائص تعامل محمَّد ﷺ مع الزمن؟
– وكيف كان ليله ونهاره؟ مساؤه وصباحه؟ بكُرُه وأصيله؟ سحَرُه وظهيرته؟ صلّى الله عليه وسلم.
إنـَّنا لا ندَّعي السبق في هذا الموضوع، بل ثمَّة محاولات من المتقدِّمين، وأخرى من كتَّاب معاصرين، لكنَّها في رأينا تحتاج إلى من يضبطها في منحىً متَّسق، وفي قالب معاصر، يجيب على بعض إشكالات العلوم الزمنية، ويوظِّف مصطلحاتها ومناهجها..
بل الحاجة أكثر إلحاحاً إلى علم قائم بذاته، يتَّخذ من الزمن مادَّة لكلِّ محاوره، لا الزمن الفزيائي، أو الفلكي، أو الفلسفي.. ولكن الزمن كوعاء للخير وللشرِّ، وكمسرح للإنسان – أيِّ إنسان – عبر فصول حياته؛ معتمدا على النصوص الشرعية في بنائه وصياغته..
وأوَّل هذه النصوص مكانة، وأقدسها شرفا: السنَّة النبوية، بعد القرآن الكريم. بل السنَّة الشريفة، كبيان للقرآن العظيم.. ومن وراء هذه الخطوات نرمي إلى استجلاء أصول وجذور البرمجة الزمنية في الفكر الإسلاميِّ.
ومن أجل ذلك ألِّف هذا الفصل، وصيغت مباحثه وعناوينه.. وأوَّل مباحثه: عرض للمحاولات التراثية، ثم اقتراح الأصول وبناء البرنامج اليوميِّ من خلال سنَّة المصطفى ﷺ.
والله المستعان..
المبحث الأوَّل: المحاولات السابقة في البرمجة اليومية.
أثناء البحث عن البرمجة اليومية للرسول ﷺ، وقعتُ على جملة من الكتابات حول تقسيم اليوم إلى محطَّات، بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنَّة النبويـَّة، وبالرجوع أحيانا إلى مجال الطبِّ وعلم التربية وعلم النفس.. ولقد عثرت على ثماني محاولات، واستثنيت منها ما كان اختصارا وتلخيصا؛ وما اندرج ضمن فضائل الأوقات([2])، فهو كثير، ولا يلحق بالبرمجة الزمنية؛ لأنـَّه في جوهره إلحاق أفضال بأزمان، وهو مختلف عن إلحاق أعمالٍ بأزمان.
ومما يُستثنى كذلك ما ألِّف في أذكار اليوم والليلة؛ لأنـَّه رغم كونه توزيعا لأعمال على أزمان، إلاَّ أنـَّه مقتصرٌ على الذكر والدعاء والصلاة دون غيرها من الأعمال، وهذا النوع من المؤلَّفات كذلك كثير في التراث الإسلاميِّ([3]).
ولا أدَّعي استقراء جميع المراجع والمصادر، ولكنني أعتقد أنَّ هذا العدد كاف لإعطاء صورة واضحة للبرنامج اليومي في المحاولات السابقة، سواء المتقدِّمة منها أو المعاصرة.
وهذه المحاولات، هي حسب ترتيبها الزمني:
أولا- المتقدمون:
1- الغزالي في إحياء علوم الدين (ت. 505هـ/1111م):
عقد كتابا سماه بـ«كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل»، وقد قسَّم اليوم إلى أوراد: سبعةٌ بالنهار، وأربعةٌ بالليل.
فأوراد النهار: ما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد، وما بين طلوع الشمس إلى الزوال وردان، وما بين الزوال إلى وقت العصر وردان، وما بين العصر إلى المغرب وردان.
وأوراد الليل: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الشمس. وتفصيل ذلك كالآتي:
أوراد النهار:
الورد الأول- ما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس: ويُشغل بالأدعية المأثورة، وركعتي الفجر في بيته، وبصلاة الفجر جماعة، ثم القعود في المسجد إلى طلوع الشمس مكرِّرا للأذكار والأدعية، وجملة من الآيات وردت الأخبار بفضلها. وليُعمل عقله كذلك في هذا الوقت بأنواع الفكر. وجملة وظائف الصبح أربعة: الدعاء، والذكر، والقراءة، والفكر([4]).
الورد الثاني- ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار (ثلاث ساعات من النهار): وفيه وظيفتان زائدتان على وظائف الصبح، وهما: صلاة الضحى، «والخيرات المتعلِّقة بالناس، التي جرت بها العادات بكرة، من عيادة مريض، وتشييع جنازة، ومعاونة على برٍّ وتقوى، وحضور مجلس علم»([5]).
الورد الثالث- من ضحوة النهار إلى الزوال: الوظائف الأربعة، بزيادة وظيفتين: الاشتغال بالكسب، وحضور السوق، و«يُقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه، مهما قدر على أن يكتسب في كلِّ يوم لقوته، فإذا حصل كفاية يومه فليرجع إلى بيت ربـِّه وليتزوَّد لآخرته»([6]). والوظيفة الثانية هي القيلولة، وهي سنَّة يستعان بها على قيام الليل. وليستيقظ قبل الزوال ليحضِّر للصلاة([7]).
الورد الرابع- ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر: وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، يصلِّي أربع ركعات، ويصلِّي الظهر جماعة، ثم يصلِّي بعد الظهر أربعا([8]).
الورد الخامس- ما بعد الظهر إلى العصر: ويستحبُّ فيه العكوف في المسجد للذكر والصلاة وضروب الخير، والنوم لمن لم ينم قبل الظهر([9]).
الورد السادس- إذا دخل وقت العصر: النافلة، والفرض جماعة، ثم الاشتغال بالأوراد الأربعة: الدعاء، والذكر، والقراءة، والفكر([10]).
الورد السابع- إذا اصفرَّت الشمس: للتسبيح والاستغفار. ثم محاسبة النفس على ما مضى من أوراد اليوم([11]).
أوراد الليل:
الورد الأول- إذا غربت الشمس: صلاة المغرب جماعة، وإحياء ما بين العشاءين بالصلاة([12]).
الورد الثاني- يدخل بدخول وقت العشاء الأخيرة إلى حدِّ نومة الناس: فرض العشاء، وصلاة قيام الليل لمن أخذ بالحزم، ثم الوتر قبل النوم لمن لم يكن عادته القيام([13]).
الورد الثالث- النوم: وليعدَّه من أوراد اليوم، وليراع فيه آداب النوم([14]).
الورد الرابع- يدخل بمضيِّ النصف الأول من الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه: وفيه التهجد، وهي الصلاة بعد نومة، وفيه أدعية مأثورة([15]).
الورد الخامس- السدس الأخير من الليل– والوظيفة فيه الصلاة([16]).
وقد ربط بكلِّ ورد من الأوراد ما تعلَّق به من عبادات وأدعية مأثورة عن الرسول غالبا، وعن جملة من العبَّاد والزهَّاد المشهورين؛ وكانت مصطلحاته صوفية في غالبيتها، والوظيفة التي مثَّل بها هي وظيفة العابد. الذي عرَّفه بأنـَّه «المتجرِّد للعبادة، الذي لا شغل له غيرها أصلا، ولو ترك العبادة لجلس بطَّالاً»([17])، و«يقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه، مهما قدر على أن يكتسب في كلِّ يوم لقوته»([18]).
ثم سرد سلَّم الوظائف، وذكر ما يميِّز كلَّ وظيفة في برنامجها اليوميِّ، بالإضافة إلى العبادة المستغرقة لجميع اليوم، والوظائف هي: وظيفة العابد، والعالم، والمتعلِّم، والمحترف، والوالي، والموحِّد المستغرق بالواحد الصمد. وهذه الأخيرة أعلى الدرجات عند الغزالي، لكن كلُّ أصحاب هذه الوظائف «مهتدون، وبعضهم أهدى من بعض (…) وإنـَّما يتفاوتون في درجات القرب لا في أصله، وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به، وأعرفهم به لا بدَّ وأن يكون أعبدهم له، فمن عرفه لم يعبد غيره»([19]).
ويكون الغزالي – حسب ما وصل إلينا – أوَّل من اقترح برنامجا يوميا متكاملا للمسلم، وفصَّل جوانب حياته بدقَّة وترتيب زمنيٍّ محكم، ثم اختصر عبد الرحمن بن الجوزي (ت. 597هـ/1200م) هذا الباب في كتابه “منهاج القاصدين”([20])، ثم اختصر نجمُ الدين ابن قدامة المقدسي (ق. 7هـ/13م) “منهاج القاصدين” في كتابه “مختصر منهاج القاصدين”. ولقد تعاقب طلبة العلم على دراسة هذا المختصر، والإفادة منه قديما وحديثا([21]).
ومن أبرز إيجابيات هذا البرنامج اليومي الذي اقترحه الغزالي، نذكر:
- استيفاءه لجميع أوقات اليوم، دون استثناء.
- اعتماده النصوص الشرعية، من قرآن كريم وسنَّة نبوية شريفة.
- تعرُّضه لأعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال الجوارح جميعا.
- تنبيهه إلى اختلاف البرنامج اليومي باختلاف الوظائف، وتقسيمه لأنواع الوظائف.
- اتخاذ الصلاة مرجعا يعود إليه المبرمج، وحدًّا بين ورد وآخر، وبين عمل وآخر..
- إشارته إلى بعض القواعد التي يُبنى عليه البرنامج اليوميُّ للمسلم، مثل قاعدة المداومة، وقاعدة الانتقال بين الأعمال لدفع الملل..
- تفريقه بين الأعمال المستغرقة لجميع اليوم، والأعمال المؤقَّتة بأوقات معيَّنة، فالأولى هي الذكر والفكر، اللذين «ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها»([22]). والثانية مثل النوم، «فقد كان نومهم غلبة»([23])، ومثل «الخيرات المتعلِّقة بالناس، التي جرت بها العادات بُكرةً»([24]).
أمَّا السلبيات المسجلَّة على هذا البرنامج اليومي، فهي:
- تغليب وظيفة العبادة على سائر الوظائف، ففي ترتيبها لم يكن موفَّقا في ضبط سلَّم تصاعديٍّ من المهمِّ إلى الأهمِّ، بل إنَّ الترتيب وضع على أساس عشوائي، هكذا: العابد، والعالم، والمتعلِّم، والمحترف، والوالي، والموحِّد المستغرق بالواحد الصمد. والخطأ أنَّ العبادة، والتوحيد والاستغراق، ليسا من جملة الوظائف، ولا يمثلان زمنا مهيمنا، بل هما من نوع الصبغة، الذي يجب أن يلازم جميع الوظائف، مهما اختلفت مكانتها.
- عدم الاهتمام ببرنامج عامَّة المسلمين، اهتماما ذا بال، وإنـَّما برمج للمشتغلين بالزهد والعبادة، أي أنَّ البرنامج أسِّس على الأمثل – في ذلك – لا على الأدنى والأيسر.
- الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، لتقوية فكرة ما على حساب أخرى، ولتقوية منحاه التصوُّفي الواضح، مما دفع بابن الجوزي والمقدسي لمحاولة حذف أغلبها.
- عدم ضبط الأولويات بحيث يُعرف ما يقدَّم على ماذا، وما هو الأهمُّ من المهمِّ، ضبطا يساعد المبرمج على مراعاة ميزان الأعمال.
- غياب أوراد المرأة، فلم يورد ولو إشارة إلى برنامجها اليوميِّ، أو يدرج حقَّها وحقَّ الأهل في برنامج الرجل، رغم كونها في سيرة المصطفى ﷺ ركيزة في البرنامج الزمني؛ لم يضِع حقُّها عند الرسول ﷺ، ولا عند الصحابة رضوان الله عليهم.
- غياب العمل الجهاديِّ الذي هو في عمقه من أبرز الوظائف، ولقد شغل حيِّزا كبيرا من حياة الرسول ﷺ، والصحابة من بعده. كما أنَّ القرآن الكريم أولاه عناية خاصَّة ومكانة معتبرة.
2- ابن العربي في تفسيره “أحكام القرآن” (543هـ/1148م):
قسَّم الأوقات قسمين: أوقات عبادة وأوقات عادة؛ وقسَّم اليوم أقساما، لخَّصها في نموذج عاشه، فقال: «كنَّا بثغر الإسكندرية مرابطين أياما، وكان في أصحابنا رجل حدَّاد، وكان يصلِّي معنا الصبح، ويذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم يحضر حلقة الذكر، ثم يقوم إلى حرفته، حتى إذا سمع النداء بالظهر رمى بالمرزبـَّة([25]) في أثناء العمل وتركه، وأقبل على الطهارة، وجاء المسجد فصلَّى وأقام في صلاة أو ذكر حتى يصلِّي العصر، ثم ينصرف إلى منـزله في معاشه، حتى إذا غابت الشمس جاء فصلَّى المغرب، ثم عاد إلى فِطره، ثم يأتي المسجد فيركع أو يسمع ما يقال عن العلم، حتى إذا صلَّى العشاء الآخرة انصرف إلى منـزله»([26]).
ويسجَّل له اعتماده الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، في ضبط البرنامج اليوميِّ للمسلم، واتخاذه الصلاة مرجعا لجميع الأعمال، وتمثيله ببرنامج الحدَّاد – وهو محترف – تمثيلا يقرِّب الصورة إلى الذهن، وسردُه لأغلب أوقات اليوم دون أن يجمعها في مصطلح واحد.
وابن العربيِّ لم يستغرق جميع أعمال اليوم، ولم يقترح برنامجا شاملا، بل إنـَّه خلط بين أقسام النهار الخمسة، واختزل بعض الأوقات الطويلة في عمل واحد، ولم يضبط اختلاف الوظائف وأثرها في البرمجة، كما أنـَّه نحَا نحو المتصوِّفة بتغليبه للعبادات والأذكار على العمل الحركيِّ.
3- ابن الحاج، في “المدخل” (ت. 737هـ/1336م):
يعتبر “المدخل” من بين كتب الآداب الشرعية، تعرَّض المؤلِّف فيه إلى جملة من أعمال اليوم والليلة بالنسبة لطالب العلم، وذلك تحت عنوان: «فصل في أوراد طالب العلم»([27])، و«فصلٌ، ينبغي للمريد أن يكون أشدَّ الناس نظرا إلى نعم الله تعالى عليه»([28]).
فتحت العنوان الأوَّل، وجَّه المؤلِّف تحليله إلى وجوب «أن لا يخلِّي طالب العلم نفسه من العبادات، واستدلَّ بحديث: «واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة»([29])، ثم وازن بين النوافل والعلم في حقِّ طالب العلم، فحدَّد الأولوية في ذلك بقوله: «وليحذر أن يتكلَّف من العمل ما عليه فيه مشقَّة، أو يخِلَّ باشتغاله بالعلم»([30])، ثم وزَّع عليه أنواع العبادات اليومية من صلاة الضحى، وقيام الليل، وركَّز على الديمة وأثرها على الأعمال.
ولكن تحت العنوان الثاني كان أظهر في تقسيم يومِ الطالب([31])، فذكر أنَّ:
- المريدَ يصبح عليه الصباح فينهض إلى صلاة الصبح في وقتها جماعة.
- بعد الصلاة يجلس في مجلس العلم.
- ثم يأتي إلى من يعتقده فيتكلَّم معه في مسائل الخير.
- ثم يصلِّي بقية الصلوات في جماعة.
- وإن فتح له شيء من أوراد الليل أو أوراد النهار «فبخ بخ».
وزاد المسألة تعميقا في أصول العقيدة حين ربط البرنامج اليوميَّ بمفهوم الكفر، فذكر أنَّ من لم يفتح عليه في هذه الأوراد «يُخاف عليه، لقوله تعالى: [ولئن كفرتم إنَّ عذابي لشديد]. والكفر عامٌّ»، وهذا الكفر هو كفر النعم، أو هو كفر دون كفر([32]).
وما يلاحظ لابن الحاج أنـَّه أعطى البرنامج اليوميَّ أبعادا فقهية وعقدية، وضبط الأولوية بين العلم والعمل بالنسبة لطالب العلم، غير أنـَّه لم يستوف جميع الأزمنة، ولم يفصِّل في الأعمال التي تسقط عليها، ولعلَّ هذا ما يلاحظ على كتب الآداب الشرعية الأخرى، والتي يمثِّل “المدخل” أحسن نموذج لها، في البرمجة اليومية وأصولها([33]).
4- بهاء الدين العاملي، في “مفتاح الفلاح” (ت. 1030هـ/1620م):
“مفتاح الفلاح” من مؤلَّفات الشيعة([34])، جعل فيه المؤلِّف محور البرنامج اليومي حركةَ الشمس، واعتمد في ذلك على حديث روي عن رسول الله ﷺ، يوصي فيه الإمامَ عليًّا رضي الله عنه قائلا: «يا علي، كنَّا مرَّة رُعاة الإبل، وصرنا اليوم رُعاة الشمس»([35]). فقسَّم اليوم إلى ستَّة مراحل، وقسَّم المراحل إلى ساعات([36]):
أ- فجر الشمس: فجر كاذب وفجر صادق.
ب- طلوع الشمس:
الساعة الأولى: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
الساعة الثانية: من طلوع الشمس إلى ذهاب حمرتها.
الساعة الثالثة: من ذهاب حمرتها إلى ارتفاع النهار.
الساعة الرابعة: من ارتفاع النهار إلى الزوال.
ج- زول الشمس:
الساعة الخامسة: من زوال الشمس إلى مضي مقدار أربع ركعات.
الساعة السادسة: من مضي أربع ركعات قبل الظهر إلى صلاة الظهر.
الساعة السابعة: من صلاة الظهر إلى مضي أربع ركعات من قبل العصر.
الساعة الثامنة: من مضي أربع ركعات قبل العصر إلى صلاة العصر.
الساعة التاسعة: من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتان.
الساعة العاشرة: من ساعتين بعد صلاة العصر إلى قبل اصفرار الشمس.
الساعة الحادية عشرة: من قبل اصفرار الشمس إلى اصفرارها.
الساعة الثانية عشرة: من اصفرار الشمس إلى غروبها.
د- غروب الشمس: وقت المغرب، وقت العشاء.
هـ-غيبة الشمس: من وقت النوم إلى منتصف الليل.
و- مقدِّمة فجر الشمس: من منتصف الليل إلى الفجر.
ويبدو التكلُّف واضحا في تقسيم المراحل، ليصل بها إلى اثنتي عشرة ساعة، والهدف هو نسبة كلِّ ساعة من الساعات إلى إمام من الأيمة الاثني عشر، بدءً بالإمام عليٍّ المنسوب إليه الساعة الأولى، وانتهاء بالساعة الثانية عشرة المنسوبة للخلف الحجَّة، وكلُّ ساعة تمتاز بأدعية مأثورة عن النبي، وعن الأيمة الشيعة.
والكتاب موجَّه لمن يحترف العبادة بمعنى الشعائر، مع إشارات خفيفة لغيره في بعض المراحل. مثل قوله: «ومما ينبغي أن يُعمل في صدر النهار التصدُّق بما تيسَّر، وإن كان حقيرا»([37])، وقوله: «ومما جرت العادة بفعله في أثناء هذا الوقت – أعني ما بين طلوع الشمس والزوال – الأكل والشرب»([38]).
ويُنتقد على العاملي أغلب ما انتقد على الغزالي، ويُعترف لكتابه بأنـَّه أوَّل كتاب مستقلٍّ في البرمجة اليومية – حسب ما توصلنا إليه – مرتَّبا بالمراحل، ومقسَّما إلى أعمال، لكلِّ عمل محلُّه من عجلة اليوم، ليلِه ونهاره، باعتماد القرآن الكريم، والسنة النبوية، ثم الآثار المروية.
ثانيا- من المعاصرين:
5- سويدان، في كتابه “الصلاة صحة ووقاية وعلاج” (1394هـ/1974م):
قسَّم اليوم إلى مراحل، تفصل بين كلِّ مرحلة وأخرى صلاةُ الفرض، مبتدئا بصلاة الصبح. فقد كانت له إشارات بارزة، وربطٌ متميِّز بين الطبِّ وعلم النفس في تحديد الحكمة من البرمجة اليومية على المنهج الإسلامي.
فالمرحلة الأولى- من الصبح إلى الظهر: يميِّزها صلاة الفرض، والنشاط في هذا الوقت موافق للطبيعة «وإذا نظرنا إلى الطير، فإنـَّها تغدو مبكِّرة، تسعى للرزق مرحة مهلِّلة، وهي تسبِّح بحمد الله»([39]). وفي هذا الوقت «يكون الجسم والعقل قد تخلَّصا من تعب وإرهاق اليوم السابق، مما يجعلهما في أعلى درجات النشاط»([40]).
وبعد الصلاة تأتي فترة العمل اليوميِّ، مناسبة «لأطول فترة من ضوء النهار، إذ التبكير بالعمل ما هو إلاَّ زيادة فترة مباشرة العمل في ضوء النهار، فليس البدء بالعمل عند الفجر، كالبدء بالعمل عند الضحى أو الظهر»([41]).
المرحلة الثانية- بين الظهر والعصر: بحلول الظهر يكون حوالي ست ساعات من العمل قد مرَّت، «وهذه الفترة تكاد تكون متوسِّط العمل اليومي للشخص العاديِّ»([42]). وتنتهي بالطهارة والوضوء فيتخلَّص الموظَّف «من أيِّ عامل يهيئ الطريق لانتشار الأمراض، وخاصَّة الأمراض التي تنتشر بالأيدي قبل تناول وجبة الغداء، كما أنـَّه بالصلاة تتخلَّص من العوامل النفسية والإرهاق النفسي والانفعالات التي قد تكون اعترضته أثناء قيامه بالعمل، وبذلك يكون متهيِّئًا لتناول وجبة الغداء، دون تداخل هذه المؤثرات في عملية الهضم على أحسن وجه»([43]).
وبعد الغداء تأتي فترة استرخاء إلى ما قبل العصر، والمعروف طبِّيا «أنَّ الاسترخاء أو على الأقلِّ تجنُّب أيِّ مجهود جسمانيٍّ لفترة بعد تناول الطعام، يوفِّر المقدار المطلوب من الدم للجهاز الهضمي»([44]).
المرحلة الثالثة- بين العصر والمغرب: مرحلة نشاط ثانية، يكون الإنسان فيها مهيَّأً جسميا ونفسيا لمواصلة العمل اليوميِّ حتى الغروب.
المرحلة الرابعة- من المغرب إلى العشاء: تؤدَّى صلاة المغرب قبل وجبة العَشاء، وتؤدِّي نفس الغرض الذي تؤديه صلاة الظهر، طبيًّا ونفسيًّا، ويعقب الوجبة حركات إقامة صلاة العِشاء([45]).
المرحلة السادسة- بين العشاء والصبح: هي ختام النشاط اليومي، وينام العبد بفضل الصلاة على «النظافة، والهدوء الروحيِّ، والخشوع، والرضا، والتخلُّص من جميع الانفعالات التي يكون الإنسان قد تعرَّض لها أثناء العمل اليومي. وبذلك ينام الليل دون أرق أو قلق، فيستعيد الجسم حيويته ونشاطه لليوم التالي»([46]).
يبدو أنَّ سويدان قد أسَّس برنامجه على حديث “أفلح إن صدق”، ونصُّه: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام; فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال : لا إلاَّ أن تتطوَّع … فأدبر الرجل , وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه; فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق»([47]) قال ابن حزم: «لا يحمَّق من ترك ما ليس فرضا»([48]).
مما يُنتقد على هذا البرنامج اليومي اقتصاره على الفرض، وعدم إدراجه لحقوق الأهل والأرحام، وعدم ضبطه لفترة القيام بهذه الحقوق، وكذا عدم اعتماده الحديث النبويَّ الشريف، كمرجع من المراجع الأساسية في البرمجة، وعدم تحديد القواعد الأساسية للبرمجة… ويشفع للمؤلِّف كون كتابه غير متخصِّص في الزمن، ولا في البرمجة الزمنية.
6- القرضاوي في “الوقت في حياة المسلم” (1405هـ/1985م):
ذكرنا في الفصل الأوَّل من هذا البحث أنَّ ما سجَّله القرضاوي في هذا الكتاب عن نظام الحياة اليومي للمسلم، يعدُّ من عمق البرمجة الزمنية، فهو بمثابة الإرهاصات الحقيقية لهذا المجال الخصب من الدراسة([49]).
ولقد ضبط القرضاوي بعض الأسس المعتبرة في بناء البرنامج اليومي للمسلم، أهمُّها: «المسارعة في الخيرات»([50])، و«الاعتبار بمرور الأيام»([51])، و«تنظيم الوقت»([52])، و«لكل وقت عمله»([53])، و«تحرِّي الأوقات الفاضلة»([54]).
ثم تدرَّج مع فترات اليوم، فإنـَّه «ينبغي للمسلم إذا أراد أن يبارَك له في عمره أن يسير على نظام الحياة اليومي في الإسلام»([55]).
الفترة الأولى- منذ مطلع الفجر، أو على الأقلِّ قبل مشرق الشمس «وبهذا يتلقَّى الصباح طاهرا نقيًّا، قبل أن تلوِّثه أنفاس العُصاة، الذين لا يفيقون من نومهم إلاَّ في ضحى النهار»([56])، وهنا يستقبل المسلمُ يومه بالبكور، الذي دعا الرسول لأمته بالبركة فيه.
واستشهد بأحاديث في فضل هذا الوقت، وبأذكار الصباح المأثورة عن الرسول ﷺ، وبما ينبغي أن يقرأه من القرآن الكريم.
وأثناء هذه الفترة يتناول المسلم «فطوره باعتدال، ثم يتوجَّه إلى عمله، ساعيا في تدبير معاشه، وطلب رزقه، يجتهد أن يشغل نفسه بأيِّ عمل حلال، مهما كان من ذوي الثراء والمال»([57]). وليكن رزقه من حلال، ويحذر الربا والحرام.
ولقد ذمَّ الإسلام التعطُّل، و«شبَّه بعضُ الصالحين الصوفيَّ الذي لا حرفة له بالبومة الساكنة في الخراب، ليس فيها نفع لأحد»([58]).
ومن الواجبات اليومية الأكيدة: واجب المسلم نحو المجتمع، «ومساعدة أفراده على قضاء حوائجهم»([59]). وفي ذلك شواهد كثيرة من السنة النبوية الشريفة، أوردها القرضاوي من مصادرها.
الفترة الثانية- بداية من الظهر، يهرع فيها المصلِّي لصلاته، على أن تكون في المسجد([60]). ثم يتناول غداءه من طيَّب ما رزق الله، غير مسرف ولا متقشِّف([61]).
و«في البلاد الحارَّة، وفي فصل الصيف فيها خاصَّة، قد يحتاج بعض الناس إلى قيلولة يخلدون فيها إلى شيء من الراحة، يستعينون بها على قيام الليل، ويقظة البكور»([62]).
الفترة الثالثة- بداية من العصر، يصلِّيها المسلم جماعة، ولا يجوز أن يُشغل عنها([63]).
الفترة الرابعة- عند غروب الشمس، يبادر المسلم إلى صلاة المغرب لأوَّل وقتها «وبخاصَّة أنَّ وقتها ضيِّق»([64]). ثم يدعو بما أثر من أدعية المساء.
الفترة الخامسة- وقت العِشاء، وقد يصلِّيها قبل العَشاء، غير أنـَّه إذا اجتمعا قدَّم العَشاء كما في الحديث. و«يستطيع المسلم أن يقضي بعض الحقوق قبل نومه، كبعض الزيارات أو المجاملات»([65]).
وفي هذا الوقت يحرص على بعض القراءة المنتظمة، طلبا للزيادة في العلم. ولا حرج عليه أن يمتِّع نفسه ببعض اللهو والترفيه المباح([66]).
ولا يحسن بالمسلم أن يطيل السهر، حتى لا يطغى على حقوقه نحو الله، ونحو الوالدين، والأرحام، والضعفاء، وكلِّ ما يجب الإحسان نحوه([67]).
وبرنامج القرضاوي في مجمله شامل، ومؤسَّس على أصول من القرآن الكريم والسنَّة النبوية الطاهرة، وضابط لجملة من القواعد الأساسيَّة… وهو مع ذلك مخلٌّ في بعض الجوانب، منها عدم اعتبار الاختلاف في الوظائف، والاسترسال في العرض دون ترتيب وتنظيم معتبر، فميَّزه الانتقال من موضوع إلى موضوع، ومن نقطة إلى أخرى شجونا واستطرادا، فهو يعرض لنقطة في مكان، ثم يعود إليها؛ ويعتبر بعض الأمور فيضع لها عنوانا، ويعرض أمورا أهمَّ منها في سياق الكلام…
ومن نقائصه عدم البرمجة لِما بين العصر والمغرب، وعدم عرضه للفروق بين الرجل والمرأة في البرنامج اليومي، وعلاقات التأثير والتأثر بينهما. فالدراسات الزمنية في عمقها دراسات تأثير وتأثر، في مختلف مناحي الحياة.
7- الشنتوت في كتاب “دور البيت المسلم” (1414هـ/1994م):
من منطلق حضاري-تربوي يعرض المؤلِّف برنامجه اليومي، فيقول: «المرجوُّ من البيت المسلم أن يكون متميِّزا، لينجب أطفالا متميِّزين، وبالتالي يقدِّم للأمَّة الإسلامية أفرادا مسلمين متميِّزين» ثم يعيد ذلك إلى برنامج يوميٍّ متميِّز للبيت المسلم، فيقول: «وتقع مسؤوليَّة ذلك على الأب المسلم والأمِّ المسلمة، اللذان يعوِّدان أفراد الأسرة كلَّهم على هذا اليوم، ويكونان قدوة لهم في ذلك»([68]).
ويعرض الشنتوت معالم اليوم الأساسية، وهي:
أ- الاستيقاظ المبكِّر، وأداء صلاة الفجر، ثم تلاوة ورد من القرآن، ثم إفطار خفيف، ثم العمل اليومي «وينبغي للبلدان المسلمة أن تجعل بدء العمل بعد صلاة الفجر»([69]) وفي الحديث: «اللهمَّ بارك لأمَّتي في بكورها»([70]).
ب- يستمرُّ العمل إلى صلاة الظهر، فتؤدَّى جماعة، ثم يُكمل المسلم العمل، ليعود إلى بيته، ويتناول الغداء، ثم ينام القيلولة، وهي ضرورة([71]).
ج- ينهض من القيلولة على أذان العصر، ليؤدِّيها جماعة، «ثم يجلس نصف ساعة أو ساعة مع أسرته، يقضيها في التعلُّم»، ثم يعود لعمله اليوميِّ، أو يقضي بعض الواجبات الاجتماعية، أو يمارس أنشطة ثقافية([72]).
د- يصلِّي المغرب، ويمكث في المسجد، لتلاوة القرآن، أو تذاكر العلم إلى العِشاء([73]).
هـ- يتناول طعاما خفيفا للعَشاء بعد الصلاة، ثم ينام إن لم يكن له علم يشغله عن النوم([74]).
ومما ميَّز برنامج الشنتوت ذكره لخصوصية شهر رمضان، وما يقع فيه من أخطاء من قِبل المسلم المعاصر، الذي اعتاد أن يجعل الليل نهارا والنهار ليلا. وكذا ذكرُه لخصوصية يوم العطلة وما ينبغي أن يُفعل فيه([75]).
ويلاحَظ المنحى التربوي في هذا المقترح، والاهتمام بحقِّ العائلة والأولاد، أكثر من غيرهما من الحقوق، باقتراح وقت بين العصر والمغرب لتعليمهم، وهو ما افتقده سابقوه.
ويُنـتقد عليه عدم فصله بين وظائف المبرمج لهم، وعدم اعتماده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كما ينبغي. وبخاصَّة إغفاله وضع قواعد تُبنى عليها البرمجة اليومية، لأنها المرتكز الأساس، وبغيرها لا يُتوصَّل إلى برنامج متميز ومرن في آن واحد.
8- الخالدي، في “الخطَّة البرَّاقة” (1418هـ/1998م):
تحت عنوان «مع صاحب العلم في ساعات يومه»، أدرج المؤلِّف جملة من النصائح، قبل أن يعرض الأعمال على شريط اليوم، وخلاصة هذه النصائح هي:
- أن يبرمج ساعات يومه، ولصاحب العلم «في التعامل مع ساعات يومه طريقة» مختلفة عن سائر الناس([76]).
- أن يحذر الغفلة، وهي «العدوُّ اللدود الذي يضيِّع على صاحب العلم ساعات يومه»، ومن أشدِّ أنواع الغفلة على طالب العلم «الغفلة عن حياته وغاياته، وقضاءُ يومه في ضياع، وحيرة، وفوضى»([77]).
- الشعور بقيمة الساعات، وصاحب العلم «يتمنَّى لو ضوعفت ساعات يومه، ولو كانت خمسين أو ستين ساعة»([78])، لمعرفته بقيمة الوقت وأثره على حياته..
- مراعاة تفاوت الساعات حسب الفصول، فينبغي على طالب العلم أن يتكيَّف مع كلِّ فصل حسب طبيعته([79]).
- أن لا ينام أكثر من ست ساعات في اليوم، وهذه «نسبة فطرية معقولة»([80]). وأن يحسن اختيار وقت النوم، فيتفادى السهر، ولا ينام في البُكر، وبذلك «يتوافق مع السنَّة الربانية الكونية في النوم واليقظة»([81]). ويتوافق كذلك مع سنَّة المصطفى عليه السلام([82]).
وبعد هذه النصائح والمقدِّمات، اقترح الخالديُّ نموذجا لبرنامج مثاليٍّ، يسترشد به طالب العلم «في وضع برنامجه الخاصِّ به»([83]). وهو كالآتي:
أ- ساعة قبل الفجر: للتهجُّد، وتلاوة القرآن، والوتر. وهذه الساعة في مجملها للتربية الروحيَّة، «ولا يجوز أن تضيع هذه الساعة الإيمانية المباركة على صاحب العلم»([84]).
ب- صلاة الفجر: يحرص أن تكون في مسجد، ويبقى في مصلاَّه بعد الفجر لأذكار الصلاة، ويكمل ورده القرآني([85]).
ج- ما بعد الشروق للعلم لا للنوم: ولا حرج أن يساعد كيانه على الانتباه «بشرب فنجان من القهوة»، وليقدِّم في هذا الوقت المسائل العلمية التي تحتاج إلى جهد وتركيز. وليحرص على صلاة الضحى بعد الشروق([86]).
د- فترة العمل أو الدراسة: من بعد الضحى إلى ما بعد الظهر، ويطلب منه أن يحسن في عمله، وهذا من أوجب واجبات الإسلام([87]).
هـ- الحرص على القيلولة: بعد الظهر، يحرص على أن ينام ساعة أو أقلَّ، اتـِّباعا للسنَّة، «لأنَّ هذه الغفوة تعيد للجسم نشاطه، وللدماغ حيويته»([88]).
و- ما بعد العصر للدعوة: العصر في المسجد، ثم الدعوة والزيارات، والواجبات الاجتماعية والإرشادية، والمشاركة في الأفراح والأتراح، وفي زيارة المرضى، ومساعدة المحتاجين، أو لجلسة عملية مع الإخوان والأصدقاء… ولا يجوز لصاحب العلم أن يعتزل المسلمين([89]).
ز- ما بعد المغرب: في المسجد، لحضور درس علميٍّ، أو تلاوة القرآن([90]).
ح- ما بعد العشاء: في العلم، وذلك قبل النوم، وليحذر الاشتغال بما لا يعني من تلفزيون، أو تمثيليات، أو مسرحيات([91]).
ط- قيام الليل، ثم محاسبة النفس: قبل النوم يتوضَّأ صاحب العلم، ويصلِّي أربع ركعات، ثم يحاسب نفسه على ساعات نهاره([92]).
ي- النوم المبكِّر: يكون النوم خمس ساعات على الأقلِّ، وعلى الأكثر ست ساعات([93]).
هذا البرنامج أقرب ما يكون إلى الشمولية، وميزته هي أنـَّه موجَّه أساسا لطالب العلم، فهو متخصِّص، ومع ذلك راعى صاحبه اختلاف الوظائف، ووضع قواعد تساعد على أن يكون برنامجا واقعيا وفعَّالا.
غير أنـَّه يبقى كمحاولة تحتاج إلى إثراء وإنماء، وتعميم على الوظائف الأخرى، وتثمين باعتبار اختلاف المدارك، واختلاف الجنس، والعمر، والإمكانات المعنوية والمادية، والطبيعة الجغرافية… واعتماد على المحاولات والتجارب السابقة… ولا يمكن ذلك بالطبع إلاَّ إذا استقامت البرمجة الزمنية – ومنها اليومية – في الفكر الإسلاميِّ، كعلم قائم بذاته، له مناهجه، ومصطلحاته، ومواضيعه… والدعوة إلى هذا من أبرز الأهداف التي يرمي إليها هذا البحث، وإلاَّ فإنَّ العلوم لا تؤلَّف في يوم، ولا تقوم من عدم، وهي جهد تراكميٌّ متواصل، غير منقطع، وغير مجزَّأ.
وخلاصة ما يلاحظ على هذه المحاولات:
- أنـَّها غير موحَّدة في المصطلح.
- وغير منتظمة في نسق منهجيٍّ واحد.
- لم تضبط القواعد العامَّة التي تحكم البرنامج اليوميَّ، بما يميِّز برنامج المسلم عن غيره من البرامج، ضبطا كافيا ومستفيضا، بل كانت ثمة إشارات وتنبيهات، لا تكفي لوضوح الرؤية وبروز المنهج.
- بعض هذه المحاولات أحدث أزمنة مهيمنة، على حساب أزمنة لا تقلُّ أهمية عنها؛ فلم تؤسَّس على مبدأ الزمن الصبغة، الذي يمثِّل روح الإسلام وعمقَه، في مجال البرمجة الزمنية واليومية.
- تعرَّضت هذه المحاولات للغايات وتطبيقاتها على البرنامج اليوميِّ، ولكن ليس كمقصد مباشر، بل عرضا دون ترتيب، علما أنَّ تحديد الغايات هي الخطوة الأساس في أيِّ برنامج زمنيٍّ، لأيِّ إنسان مهما كان.
- لا نجد اهتماما ذا بال بالأهداف ولا بالأولويات في البرنامج اليوميِّ، إلاََّّ نادرا وعرضا، ولذا كثيرا ما وقع المبرمج في اقتراحات متضاربة زمنيا، إنجازُ بعضها يلغي الأخرى طبيعيا، والاهتمام ببعضها يعني إغفال البعض الآخر ضرورة.
- لم نعثر على سلك ينتظم العلوم التي أنتجها الفكر الإسلاميُّ مع البرنامج اليوميِّ للمسلم، فكان البرنامج في معزل عن العلوم، والعلوم في منأى عن الفرد المسلم، فهي لا تخدمه مباشرة. ومن جملة العلوم المتبادرة إلى الذهن: علم العقيدة، والمقاصد، وفقه مراتب الأعمال، وفقه الأولويات، والسيرة النبوية، وعلم الرجال…
- ينقص هذه المحاولات استقصاء واستقراء للنصوص، سواء القرآنية منها أم الحديثية، مما يفرض على المنظِّر للبرنامج اليوميِّ تعارضا بين نصٍّ وآخر، وبين عمل يوميٍّ وعمل آخر يزيد عنه أهمية أو يقلُّ…
[1] – قلعه جي، محمد رواس: دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته الشريفة؛ دار النفائس، بيروت؛ ط1: 1408هـ/1988م. ص5.
[2] – انظر مثلا- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت. 458هـ/1066م): كتاب فضائل الأوقات؛ منشورات محمد علي بيضون-دار الكتب العلمية، بيروت؛ 1417هـ/1997م..
[3] – انظر مثلا- النووي، أبو زكرياء بن شرف بن مري (ت. 676هـ/1277م): ورد الإمام النووي؛ تقديم محمد سعيد رمضان البوطي؛ مكتبة الفارابي، دمشق-سورية؛ د.ت.ن.. المقريزي: مختصر قيام الليل. وذكَر حاجي خليفة في كشف الظنون جملة من هذه الكتب؛ ج2/ص1705، 1925، 1949… وانظر- القنوجي: أبجد العلوم؛ ج2/ص349. ومن الكتب المعاصرة: الغزالي، محمد: فنُّ الذكر والدعاء عن خاتم الأنبياء؛ قصر الكتاب، البليدة-الجزائر؛ 1409هـ. رضوان محمد رضوان: المأثورات، الحزب اليومي؛ نشر مجلة الشريعة، سورية؛ 1415هـ. الزغبي، محمد عبد الملك: رهبان الليل؛ مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، 1418هـ/1997م.
[4] – الغزالي: إحياء علوم الدين؛ ص393-400.
[5] – نفس المرجع؛ ص400-401.
[6] – نفس المرجع؛ ص401.
[7] – الغزالي: إحياء علوم الدين؛ ص401-402.
[8] – نفس المرجع؛ ص402.
[9] – نفس المرجع؛ ص402-403.
[10] – نفس المرجع؛ ص403.
[11] – نفس المرجع؛ ص403-404.
[12] – نفس المرجع؛ ص404.
[13] – نفس المرجع؛ ص404-406.
[14] – نفس المرجع؛ ص406-409.
[15] – نفس المرجع؛ ص409-411.
[16] – الغزالي: إحياء علوم الدين؛ ص411-412.
[17] – نفس المرجع؛ ص412.
[18] – نفس المرجع؛ ص401.
[19] – نفس المرجع؛ ص414-415.
[20] – بحثت عن كتاب منهاج القاصدين في العديد من المكتبات، وبخاصَّة في المملكة العربية السعودية، فلم أجده، ويبدو أنـَّه لم يطبع، وإنـَّما الذي طُبع واشتهر هو المختصر للمقدسي.
[21] – ابن قدامة المقدسي، أحمد بن عبد الرحمن: مختصر منهاج القاصدين؛ تقديم: محمد أحمد دهمان، تعليق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ مكتبة دار البيان-مؤسسة علوم القرآن، دمشق-بيروت؛ 1403هـ/1982م. ص3.
[22] – الغزالي: إحياء علوم الدين؛ ص392.
[23] – نفس المرجع؛ ص407.
[24] – نفس المرجع؛ ص401.
[25] – «الـمِرْزَبَة والإِرْزَبَّة: عُصَيَّة من حديدٍ. و الإِرْزَبَّة: التـي يُكْسر بها الـمَدَرُ». ابن منظور: لسان العرب: ج1/ص416
[26] – ابن العربي: أحكام القرآن؛ ج4/ص281-282.
[27] – ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري (ت. 737هـ/1336م): المدخل؛ (الأصلية: دار التراث)؛ طبعة جامع الفقه، شركة حرف، الإمارات العربية المتحدة؛ 1999م؛ ج2/ص180، ج2/ص132-139.
[28] – نفس المرجع؛ ج3/ص155-156.
[29] – رواه البخاري؛ كتاب الإيمان، باب الدين يسر؛ ج1/ص23، رقم 39؛ بسند: «حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:…». ورواه ابن حبان في صحيحه، ج2/ص63، رقم 351.
[30] – ابن الحاج: المدخل؛ ج2/ص135.
[31] – نفس المرجع؛ ج3/ص155.
[32] – ابن الحاج: المدخل؛ ج3/ص155.
[33] – تتبعت جملة من كتب الآداب الشرعية، فصلا فصلا، ومنها: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب (ت. 450هـ/1058م): أدب الدنيا والدين؛ (الأصلية: دار مكتبة الحياة)؛ طبعة جامع الفقه، شركة حرف، الإمارات العربية المتحدة؛ 1999م؛. المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي (ت. 673هـ/1274م): الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ (الأصلية: مؤسسة قرطبة)؛ طبعة جامع الفقه، شركة حرف، الإمارات العربية المتحدة؛ 1999م.
[34] – إذا كانت التجارب السابقة في البرمجة اليومية صوفية النـزعة، سنيَّة المذهب؛ فإنَّ تجربة العاملي كذلك صوفية النـزعة، غير أنـَّها شيعيَّة المذهب. بل إنَّ المذهبية أظهر وأكثر استحكاما في “مفتاح الفلاح” منها في الكتب الأخرى.
[35] – العاملي: مفتاح الفلاح؛ ص13-14.
[36] – نفسه.
[37] – العاملي: مفتاح الفلاح؛ ص50.
[38] – نفس المرجع؛ ص52.
[39] – سويدان: الصلاة صحة ووقاية؛ ص162.
[40] – نفسه.
[41] – نفس المرجع؛ ص163.
[42] – سويدان: الصلاة صحة ووقاية؛ ص163.
[43] –نفس المرجع؛ ص164.
[44] – سويدان: الصلاة صحة ووقاية؛ ص164.
[45] – نفس المرجع؛ ص165.
[46] – نفسه.
[47] – ابن حزم: المحلَّى بالآثار؛ ج2/ص4 بسند: «حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا حمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول».
[48] – المحلى بالآثار؛ ج1/ص256.
[49] – انظر أعلاه- ص47-48.
[50] – القرضاوي: الوقت في حياة المسلم؛ ص16.
[51] – نفس المرجع؛ ص18.
[52] – نفسه.
[53] – نفس المرجع؛ ص21.
[54] – نفس المرجع؛ ص22.
[55] – نفس المرجع؛ ص25.
[56] – القرضاوي: الوقت في حياة المسلم؛ ص25.
[57] – نفس المرجع؛ ص27.
[58] – نفس المرجع؛ ص27-28.
[59] – نفس المرجع؛ ص28.
[60] – نفسه.
[61] – نفس المرجع؛ ص29.
[62] – نفسه.
[63] – القرضاوي: الوقت في حياة المسلم؛ ص29.
[64] – نفس المرجع؛ ص30.
[65] – نفس المرجع؛ ص30.
[66] – نفس المرجع؛ ص31.
[67] – نفس المرجع؛ ص31-32.
[68] – الشنتوت، خالد أحمد: دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم؛ المطبعة العربية، غرداية؛ ط4: 1994م. ص137-138.
[69] – نفس المرجع؛ ص136.
[70] – انظر تخريجه، أدناه- في المبحث الموالي.
[71] – الشنتوت: نفس المرجع؛ ص136.
[72] – نفسه.
[73] – نفسه.
[74] – نفس المرجع؛ ص136.
[75] – نفس المرجع؛ ص136-137.
[76] – الخالدي: الخطة البراقة؛ ص119-120.
[77] – نفس المرجع؛ ص120.
[78] – نفس المرجع؛ ص122.
[79] – نفس المرجع؛ ص123-124.
[80] – نفس المرجع؛ ص126.
[81] – الخالدي: الخطة البراقة؛ ص127-132.
[82] – نفس المرجع؛ ص129.
[83] – نفس المرجع؛ ص133.
[84] – نفس المرجع؛ ص134.
[85] – نفس المرجع؛ ص134-135.
[86] – نفس المرجع؛ ص135.
[87] – نفس المرجع؛ ص136.
[88] – نفسه.
[89] – نفس المرجع؛ ص137.
[90] – نفس المرجع؛ ص138.
[91] – نفس المرجع؛ ص138-139.
[92] – الخالدي: الخطة البراقة؛ ص139.
[93] – نفس المرجع؛ ص139-140.
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت