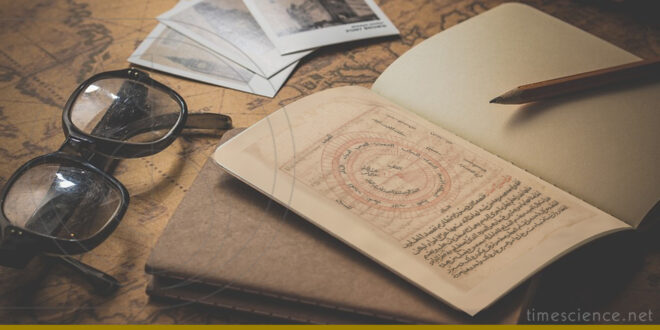بعيدا عن التعريف الحدّي للعلم، وأحيل في ذلك إلى العديد من المصادر، منها كتابي ضمن سلسلة “خلاصة المعنى” بعنوان: “العلم والعالِم: في نظرية العلم والإدراك“… أطرح الأسئلة المحورية التالية في سبيل “تأسيس علم جديد“:
- ممّ يتشكل العلم؟
- وما هي الخصائص المحدّدة لتمييز علم عن علم آخر؟
- وهل يمكن لموضوع واحد أن تعالجه علوم عديدة؟
- وهل يمكن لعلم واحد أن يعالج مواضيع عديدة؟
يقول التهانوي في “كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم”: “كل علم من العلوم المدوّنة لا بدّ فيه من أمور ثلاثة: الموضوع، والمسائل، والمبادئ (المناهج)… وهذا القول مبني على المسامحة، فإنّ حقيقة كلّ علم مسائلُه، وعدُّ الموضوع والمبادئ من الأجزاء إنّما هو لشدّة اتصالهما بالمسائل التي هي المقصودة في العلم…”.
ونظرة في كتب تصنيف العلوم، مثل “مفاتيح العلوم” للخوارزمي، و”إحصاء العلوم” للفارابي، و“نفائس العلوم” للآملي…… وكذا في التصانيف المهيمنة في علم المكتبات: تصنيف ديوي، مكتبة الكونغرس، موسوعة بريطانيكا… الخ تظهِر لنا أنَّ لا حجْر في بناء علوم على مواضيع، أو تخصيص موضوع بعلوم، إذ “يجوز أن تكون الأشياء الكثيرة موضوعا لعلم واحد، كما يجوز أن يكون للشيء الواحد علوم كثيرة؛ وذلك قائم على التسامح، وعلى العفو“.
ومثال ذلك أنهم “جعلوا أجسام العالـَم وهي البسائط موضوع علم الهيئة، من حيث الشكل، وموضوعَ علم السماء والعالم، من حيث الطبيعة”.
والقاعدة الكلية في وضع العلوم هي “أنَّ المعتبر في العلم هو البحث عن جميع ما تحيط به الطاقة الإنسانية من الأعراض الذاتية للموضوع“.
ولا بدَّ أن نضيف كذلك إلى أنَّ العلم ليس هو المعلومات؛ وإنما هو المنهج والنسق وعدم التناقض (انظر- كيث ديفلين: تحويل العلم إلى معرفة).
والعلم لا يشترط فيه أن يجيب عن كل الأسئلة، ويقول في كل المسائل؛ فالعلم والعالـِم أحيانا يعبر عن العجز، ويقول: “لا أعلم”، ذلك أنَّ مساحة المجهول أكبر من مساحة المعلوم؛ ولقد قال تعالى: “وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا”.
ولعلَّ من أظهر خصائص مجال “الزمن والوقت” الإفصاح فيه عن العجز حين يتحقق العجز، وهو ما يميزه عن علوم كثيرة، وعلماء كثر… يفترضون أجوبة بعيدة، ويبالغون في الادعاء، ولقد أبدع كارل بوبر حين صاغ نظرية “القابلية للتفنيد أو للدحض” عوض “القابلية للتحقُّق“.
 علم الزمن والوقت
علم الزمن والوقت